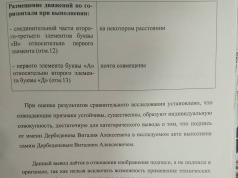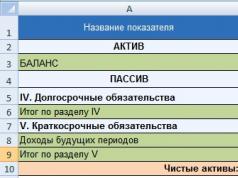تنقسم أجهزة الجهاز المناعي إلى أجهزة مركزية ومحيطية. تشمل الأجهزة المركزية (الأساسية) لجهاز المناعة النخاع العظمي والغدة الصعترية. في الأجهزة المركزية لجهاز المناعة، يحدث نضوج وتمايز خلايا الجهاز المناعي عن الخلايا الجذعية. في الأجهزة الطرفية (الثانوية)، يحدث نضوج الخلايا اللمفاوية حتى المرحلة النهائية من التمايز. وتشمل هذه الغدد الليمفاوية والعقد الليمفاوية والأنسجة اللمفاوية للأغشية المخاطية.


الأجهزة المركزية للجهاز المناعي نخاع العظام. تتشكل هنا جميع العناصر المكونة للدم. يتم تمثيل الأنسجة المكونة للدم بتراكمات أسطوانية حول الشرايين. تشكل الحبال التي يتم فصلها عن بعضها البعض بواسطة الجيوب الوريدية. يتدفق الأخير إلى الجيوب الأنفية المركزية. يتم ترتيب الخلايا الموجودة في الحبال في الجزر. تتمركز الخلايا الجذعية بشكل رئيسي في الجزء المحيطي من قناة النخاع العظمي. عندما تنضج، فإنها تتحرك نحو المركز، حيث تخترق الجيوب الأنفية ثم تدخل الدم. تمثل الخلايا النقوية في نخاع العظم 60-65% من الخلايا. اللمفاوية 10-15%. 60% من الخلايا هي خلايا غير ناضجة. أما الباقي فهو ناضج أو دخل حديثًا إلى نخاع العظم. يوميا من نخاع العظمتهاجر نحو 200 مليون خلية إلى الأطراف، أي 50% منها الرقم الإجمالي. في نخاع العظم البشري، يحدث النضج المكثف لجميع أنواع الخلايا، باستثناء الخلايا التائية. تخضع الأخيرة فقط للمراحل الأولية من التمايز (الخلايا المؤيدة لـ T، والتي تهاجر بعد ذلك إلى الغدة الصعترية). توجد أيضًا خلايا البلازما هنا، وتشكل ما يصل إلى 2% من إجمالي عدد الخلايا، وتنتج الأجسام المضادة.

تي ايموس. C متخصص حصريًا في تطوير الخلايا اللمفاوية التائية. وله إطار ظهاري تتطور فيه الخلايا الليمفاوية التائية. تسمى الخلايا الليمفاوية التائية غير الناضجة التي تتطور في الغدة الصعترية باسم THYMOCYTES. الخلايا اللمفاوية التائية الناضجة هي خلايا عبور تدخل الغدة الصعترية في شكل سلائف مبكرة من النخاع العظمي (خلايا PR-T) وبعد النضج، تهاجر إلى القسم المحيطي لجهاز المناعة. ثلاثة أحداث رئيسية تحدث في عملية نضوج الخلايا التائية في الغدة الصعترية: 1. ظهور مستقبلات الخلايا التائية التي تتعرف على المستضد في الخلايا الثيموسية الناضجة. 2. تمايز الخلايا التائية في المجموعات السكانية الفرعية (CD4 وCD8). 3. حول اختيار (اختيار) مستنسخات الخلايا الليمفاوية التائية القادرة على التعرف فقط على المستضدات الغريبة المقدمة إلى الخلايا التائية بواسطة جزيئات مجمع التوافق النسيجي الرئيسي للكائن الحي الخاص بها. يتكون التيموس البشري من فصين. وتقتصر كل واحدة منها على كبسولة تدخل منها فواصل النسيج المتصلة. يقسم السبتيا الجزء المحيطي من قشرة العضو إلى فصوص. الجزء الداخلي من العضو يسمى الدماغ.


تدخل الخلايا البروتيموسية الطبقة القشرية وعندما تنضج، تنتقل إلى الطبقة المتوسطة. من تطور THYMOCYTES إلى خلايا T ناضجة هو 20 يومًا. تدخل الخلايا التائية غير الناضجة إلى الغدة الصعترية دون وجود علامات الخلايا التائية على الغشاء: مستقبلات الخلايا التائية CD3، CD4، CD8، ومستقبلات الخلايا التائية. في المراحل الأولى من النضج، تظهر جميع العلامات المذكورة أعلاه على أغشيتها، ثم تتكاثر الخلايا وتجتاز مرحلتين من الاختيار. 1. اختيار الاختيار الإيجابي للقدرة على التعرف على الجزيئات الخاصة بمجمع التوافق النسيجي الرئيسي بمساعدة مستقبل T-Cell. الخلايا التي لا تستطيع التعرف على جزيئاتها من مجمع التوافق النسيجي الرئيسي تموت عن طريق موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا المبرمج). تفقد THYMOCYTEs الباقية واحدة من علامات الخلايا التائية الأربعة أو جزيء CD4 أو CD8. ونتيجة لذلك، فإن ما يسمى بـ "الإيجابي المزدوج" (CD4 CD8) تصبح خلايا الثيموسيت إيجابية واحدة. يتم التعبير عن جزيء CD4 أو CD8 على أغشيتهم. لذلك، تم تحديد الاختلافات بين المجموعتين الرئيسيتين من الخلايا التائية: خلايا CD8 السامة للخلايا وخلايا CD4 المساعدة. 2. الاختيار السلبي للخلايا لقدرتها على عدم التعرف على المستضدات الخاصة بالكائن الحي. في هذه المرحلة، يتم القضاء على الخلايا ذاتية النشاط المحتملة، أي الخلايا التي يكون مستقبلها قادرًا على التعرف على المستضدات الموجودة في أجسامها. يضع الاختيار السلبي أسس تكوين التسامح، أي استجابات الجهاز المناعي لمستضداته الخاصة. وبعد مرحلتين من الاختيار، يبقى 2% فقط من الخلايا الثيموسية على قيد الحياة. تهاجر الخلايا الثيموسية الباقية إلى الطبقة المتوسطة ثم تغادر إلى الدم، وتتحول إلى الخلايا الليمفاوية التائية "الساذجة".

الأعضاء اللمفاوية الطرفية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم. وتتمثل المهمة الرئيسية للأعضاء اللمفاوية المحيطية في تنشيط الخلايا اللمفاوية التائية والبائية الساذجة مع التكوين اللاحق للخلايا الليمفاوية الفعالة. هناك أعضاء محيطية مغلفة الجهاز المناعي(الطحال و الغدد الليمفاوية) والأعضاء والأنسجة اللمفاوية غير المغلفة.

تشكل العقد الليمفاوية الكتلة الرئيسية للأنسجة اللمفاوية المنظمة. وهي تقع على المستوى الإقليمي وتتم تسميتها وفقًا للموقع (الإبطي، الأربي، الجانبي، إلخ.). تحمي العقد الليمفاوية الجسم من المستضدات التي تخترق الجلد والأغشية المخاطية. يتم نقل مستضدات H-CARRONS إلى العقد الليمفاوية الإقليمية من خلال الأوعية اللمفاوية، أو بمساعدة الخلايا المتخصصة المقدمة للمستضد، أو من خلال تدفق السوائل. في العقد الليمفاوية، يتم تقديم المستضدات إلى الخلايا الليمفاوية التائية الساذجة بواسطة خلايا متخصصة في تقديم المستضد. نتيجة التفاعل بين الخلايا التائية والخلايا التي تقدم المستضد هي تحويل الخلايا اللمفاوية التائية الساذجة إلى خلايا فاعلة ناضجة قادرة على أداء وظائف وقائية. تحتوي العقد الليمفاوية L على منطقة قشرية من الخلايا البائية (المنطقة القشرية)، ومنطقة نظيرة للخلايا التائية (منطقة) ومنطقة مركزية نخاعية (الدماغ) مكونة من تجارة الخلايا التي تحتوي على الخلايا الليمفاوية التائية والبائية وخلايا البلازما والبلاعم. يتم تقسيم المناطق الفموية والقشرية عن طريق أنسجة متصلة إلى قطاعات شعاعية.


يدخل L LYMPH إلى العقدة من خلال العديد من الأوعية اللمفاوية الواردة من خلال المنطقة تحت المحفظة التي تغطي المنطقة القشرية. ومن العقدة الليمفاوية، تخرج الليمفاوية من خلال وعاء ليمفاوي واحد (مؤثر) في منطقة ما يسمى بالبوابة. من خلال البوابة من خلال الأوعية المقابلة، يدخل الدم وخارج العقدة الليمفاوية. توجد في المنطقة القشرية الجريبات اللمفاوية، التي تحتوي على مراكز التكاثر، أو "المراكز الجرثومية"، حيث يحدث نضوج الخلايا البائية التي تواجه المستضد.


تسمى عملية النضج بالنضج التقاربي. O N مصحوب بفرط طفرات جسدية لجينات الغلوبولين المناعي المتغيرة، والتي تحدث بتكرار يتجاوز 10 مرات تكرار الطفرات التلقائية. تؤدي الطفرات المفرطة C إلى زيادة في تقارب الأجسام المضادة مع التكاثر اللاحق وتحويل الخلايا B إلى خلايا منتجة للأجسام المضادة في البلازما. الخلايا البلازمية P هي المرحلة النهائية من نضوج الخلايا الليمفاوية البائية. يتم تحديد موضع الخلايا الليمفاوية التائية في المنطقة المجاورة للقشرة. يُطلق على E E اسم T-DEPENDENT. تحتوي المنطقة المعتمدة على T على العديد من الخلايا التائية والخلايا ذات التقدمات المتعددة (الخلايا التغصنية بين الرقمية). هذه الخلايا عبارة عن خلايا تقدم المستضد والتي وصلت إلى العقدة الليمفاوية من خلال الأوعية اللمفاوية الواردة بعد الالتقاء بمستضد أجنبي في المحيط. NIVE T-LYMPHOCYTES، بدورها، تدخل إلى العقد الليمفاوية مع التيار الليمفاوي ومن خلال الأوردة ما بعد الشعيرات الدموية، والتي تحتوي على مناطق ما يسمى بالبطانة العالية. في منطقة الخلايا التائية، يتم تنشيط الخلايا اللمفاوية التائية الساذجة بمساعدة الخلايا الجذعية المضادة للجنرال. ويؤدي التنشيط إلى انتشار وتكوين مستنسخات من الخلايا الليمفاوية التائية، والتي تسمى أيضًا الخلايا التائية المعززة. والأخيرة هي المرحلة النهائية من النضج والتمايز للخلايا اللمفاوية التائية. إنهم يتركون العقد الليمفاوية لأداء الوظائف الفعالة التي تمت برمجتها من خلال جميع التطورات السابقة.

الليني هو عضو ليمفاوي كبير، يختلف عن العقد الليمفاوية بوجود عدد كبير من الخلايا الحمراء. الوظيفة المناعية الرئيسية هي تراكم المستضدات التي تأتي مع الدم وتنشيط الخلايا الليمفاوية التائية والبائية التي تتفاعل مع المستضد الذي يأتي عن طريق الدم. يحتوي الطحال على نوعين رئيسيين من الأنسجة: اللب الأبيض واللب الأحمر. يتكون اللب الأبيض من الأنسجة اللمفاوية، التي تشكل اقترانات لمفاوية حول الشرايين حول الشرايين. تحتوي القوابض على مناطق T وB-CELL. منطقة تعتمد على حرف T من القابض، مماثلة للمنطقة المعتمدة على حرف T في العقد الليمفاوية، تحيط بالشرين مباشرة. تشكل بصيلات الخلايا B منطقة الخلايا B وتقع بالقرب من حافة الجبل. توجد مراكز تكاثر في الجريبات، تشبه المراكز الجرثومية في العقد الليمفاوية. في مراكز التكاثر، يتم تحديد موضع الخلايا الجذعية والخلايا البلعمية، مما يقدم المستضد إلى الخلايا البائية مع التحويل اللاحق للأخيرة إلى خلايا بلازما. تمر خلايا البلازما الناضجة عبر الروابط الوعائية إلى اللب الأحمر. اللب الأحمر عبارة عن شبكة خلوية مكونة من الجيوب الوريدية والخلايا الخلوية ومليئة بكريات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلاعم وخلايا أخرى من الجهاز المناعي. اللب الأحمر هو موقع ترسب كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية. الإضافات التي تنتهي بها الشرايين المركزية لللب الأبيض تفتح بحرية في كل من اللب الأبيض وفي اللب الأحمر. وعندما يصل الدم المتسرب إلى اللب الأحمر الثقيل فإنه يبقى فيه. هنا تتعرف البلاعم على كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية الباقية على قيد الحياة. الخلايا البلازمية، المنقولة إلى اللب الأبيض، تقوم بتركيب الغلوبولين المناعي. تمر خلايا الدم التي لا يتم امتصاصها ولا يتم تدميرها بواسطة البلعمات عبر البطانة الظهارية للجيوب الأنفية الوريدية وتعود إلى مجرى الدم مع البروتينات ومكونات البلازما الأخرى.

الأنسجة اللمفاوية المغلفة توجد معظم الأنسجة اللمفاوية غير المغلفة في الأغشية المخاطية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الأنسجة اللمفاوية غير المغلفة في الجلد والأنسجة الأخرى. الأنسجة اللمفاوية للأغشية المخاطية تحمي الأسطح المخاطية فقط. وهذا ما يميزها عن الغدد الليمفاوية التي تحمي من المستضدات التي تخترق الأغشية المخاطية والجلد. آلية التأثير الرئيسية للمناعة المحلية على مستوى الغشاء المخاطي هي إنتاج ونقل الأجسام المضادة الإفرازية من فئة IgA مباشرة إلى سطح الظهارة. في أغلب الأحيان، تدخل المستضدات الأجنبية الجسم عبر الأغشية المخاطية. في هذا الصدد، يتم إنتاج الأجسام المضادة من فئة IgA في الجسم بأكبر كميات مقارنة بالأجسام المضادة من النظائر الأخرى (ما يصل إلى 3 جم يوميًا). يشمل النسيج اللمفاوي للأغشية المخاطية ما يلي: الأعضاء والتكوينات اللمفاوية المرتبطة بها الجهاز الهضمي(الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء GALT). يشمل الأعضاء اللمفاوية في الحلقة المحيطة بالبلعوم (اللوزتين واللحمية) والزائدة الدودية وبقع باير والخلايا الليمفاوية داخل الظهارة في الغشاء المخاطي المعوي. الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالقصبات الهوائية والقصيبات (الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالقصبات الهوائية BALT)، وكذلك الخلايا الليمفاوية داخل الظهارة في الغشاء المخاطي الجهاز التنفسي. الأنسجة اللمفاوية للأغشية المخاطية الأخرى (الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالغشاء المخاطي MALT)، بما في ذلك النسيج اللمفاوي للغشاء المخاطي للجهاز البولي التناسلي باعتباره المكون الرئيسي. غالبًا ما يتم تحديد الأنسجة اللمفاوية للغشاء المخاطي في اللوحة القاعدية للأغشية المخاطية (الصفيحة المخصوصة) وفي الغشاء المخاطي. مثال على الأنسجة اللمفاوية المخاطية هي بقع باير، والتي توجد عادة في الجزء السفلي من اللفائفي. كل لوحة مجاورة لجزء من ظهارة الأمعاء تسمى الظهارة المرتبطة بالجريب. تحتوي هذه المنطقة على ما يسمى بالخلايا M. تدخل البكتيريا والمستضدات الأجنبية الأخرى إلى الطبقة تحت الظهارية من تجويف الأمعاء عبر الخلايا M. الكتلة الأساسية للخلايا الليمفاوية في رقعة باير موجودة في جريب الخلية البائية مع وجود مركز جنرالي في المنتصف. تحيط مناطق الخلايا التائية بالبصيلة بالقرب من طبقة الخلايا الظهارية. إن الحمل الوظيفي الرئيسي لرقعات باير هو تنشيط الخلايا الليمفاوية البائية وتمايزها إلى خلايا بلازما تنتج الأجسام المضادة من الفئتين I G A و I G بالإضافة إلى الأنسجة اللمفاوية المنظمة في الطبقة الظهارية للمخاط وفي الصفيحة بروبريا. إعادة أيضا الخلايا الليمفاوية التائية المنتشرة المنفردة. أنها تحتوي على كل من مستقبل ΑΒ T-CELL ومستقبل ΓΔ T-CELL. بالإضافة إلى الأنسجة اللمفاوية للأسطح المخاطية، تشتمل الأنسجة اللمفاوية غير المغلفة على: الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالجلد والخلايا الليمفاوية داخل الجلد؛ الليمف، نقل المستضدات الأجنبية وخلايا الجهاز المناعي؛ الدم المحيطي، الذي يوحد جميع الأعضاء والأنسجة ويؤدي وظيفة النقل والاتصالات؛ كتل من الخلايا اللمفاوية والخلايا اللمفاوية المفردة للأعضاء والأنسجة الأخرى. على سبيل المثال يمكن أن يكون الخلايا الليمفاوية في الكبد. يؤدي الكبد وظائف مناعية مهمة جدًا، على الرغم من أنه لا يعتبر عضوًا في الجهاز المناعي لجسم الشخص البالغ. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف الخلايا البلعمية الأنسجة للكائن الحي متمركزة فيه. إنهم يبلعمون ويحللون المجمعات المناعية، التي تجلب الخلايا الحمراء إلى هنا على سطحها. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن الخلايا الليمفاوية الموجودة في الكبد وفي الغشاء المخاطي المعوي لها وظائف مثبطة وتوفر صيانة مستمرة للتحمل المناعي (عدم الاستجابة) للطعام.

"جهاز المناعة في الجسم" - عوامل وقائية غير محددة. حصانة. آليات محددة للمناعة. عوامل. مناعة محددة. الغدة الزعترية. فترة حرجة. حاجز وقائي. مولد المضاد. مراضة السكان الأطفال. أثر في تاريخ البشرية. عدوى. الأعضاء اللمفاوية المركزية. -زيادة دفاعات جسم الطفل. التقويم الوطني التطعيمات الوقائية. الوقاية من اللقاحات. الأمصال. مناعة اصطناعية.
"جهاز المناعة" - العوامل التي تضعف جهاز المناعة. هناك عاملان رئيسيان لهما تأثير كبير على فعالية الجهاز المناعي: 1. نمط حياة الشخص 2. بيئة. التشخيص السريع لفعالية الجهاز المناعي. يساهم الكحول في تكوين حالة نقص المناعة: تناول كأسين من الكحول يقلل المناعة إلى ثلث المستوى لعدة أيام. المشروبات الغازية تقلل من فعالية جهاز المناعة.
"البيئة الداخلية لجسم الإنسان" - تكوين البيئة الداخلية للجسم. خلايا الدم. نظام الدورة الدموية للإنسان. بروتين. الجزء السائل من الدم. عناصر على شكل. سائل عديم اللون. سمها بكلمة واحدة. خلايا الدورة الدموية. عضو عضلي مجوف. اسم الخلايا. حركة الليمفاوية. الجهاز المكون للدم. لوحات الدم. البيئة الداخليةجسم. خلايا الدم الحمراء. الاحماء الفكري. سائل النسيج الضام. أكمل السلسلة المنطقية.
"تاريخ التشريح" - تاريخ تطور علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والطب. ويليام هارفي. بوردينكو نيكولاي نيلوفيتش. بيروجوف نيكولاي إيفانوفيتش. لويجي جالفاني. باستور. أرسطو. متشنيكوف ايليا ايليتش. بوتكين سيرجي بتروفيتش. باراسيلسوس. أوختومسكي أليكسي ألكسيفيتش. ابن سينا. كلوديوس جالينوس. لي شي تشن. أندرياس فيزاليوس. لويس باستور. أبقراط. سيتشينوف إيفان ميخائيلوفيتش. بافلوف إيفان بتروفيتش.
"العناصر في جسم الإنسان" - أجد أصدقاء في كل مكان: في المعادن وفي الماء، بدوني أنت كأنك بلا يدين، بدوني انطفأت النار! (الأكسجين). وإذا قمت بتدميرها على الفور، فسوف تحصل على غازين. (ماء). على الرغم من أن تركيبتي معقدة، إلا أنه من المستحيل العيش بدوني، فأنا مذيب ممتاز للعطش لأفضل مسكر! ماء. محتوى “المعادن الحياتية” في جسم الإنسان. محتوى العناصر العضوية في جسم الإنسان. دور العناصر الغذائية في جسم الإنسان.
"المناعة" - فئات الغلوبولين المناعي. تنشيط الخلايا التائية المساعدة. السيتوكينات. الحصانة الخلطية. أصل الخلايا. آلية التحكم الوراثي للاستجابة المناعية. الغلوبولين المناعي E. جزيء الغلوبولين المناعي. عناصر الجهاز المناعي. هيكل المواقع الرئيسية. الغلوبولين المناعي أ. العناصر الأجنبية. هيكل الأجسام المضادة. الأساس الجيني للمناعة. هيكل موقع ربط المستضد. إفراز الأجسام المضادة.
عرض تقديمي - محاضرة حول موضوع الجهاز المناعي وإجهاد المناعة طالب المجموعة 211 Gorkova E. N. Teacher Golubkova G. G.
 مخطط الروابط المتكاملة أصول الإخراج علم الأمراض علم الأحياء الدقيقة علم النفس الموضوع: "المناعة، جهاز المناعة، الإجهاد" علم الأدوية لمرض السكري في العلاج بيولوجيا مرض السكري في الجراحة مرض السكري في طب الأطفال مرض السكري في التوليد مرض السكري في علم الأعصاب
مخطط الروابط المتكاملة أصول الإخراج علم الأمراض علم الأحياء الدقيقة علم النفس الموضوع: "المناعة، جهاز المناعة، الإجهاد" علم الأدوية لمرض السكري في العلاج بيولوجيا مرض السكري في الجراحة مرض السكري في طب الأطفال مرض السكري في التوليد مرض السكري في علم الأعصاب
 يتعرف جهاز المناعة في الجسم على الأجسام والمواد الغريبة ويعالجها ويزيلها، ويوحد الأعضاء والأنسجة التي تحمي الجسم من الأمراض. أرز. 1 الأعضاء المركزية 1-نخاع العظم الأحمر (المشاشية عظم الفخذ); 2- الغدة الصعترية (الغدة الصعترية) الشكل 2. 2 الأجهزة الطرفية 1-الحلقة اللمفاوية الظهارية لبيروجوف (اللوزتين): أ - البلعوم، ج - الحنكي، ب - البوق، د - اللسان؛ 2- الطحال. 3- العقد الليمفاوية؛ 4- الزائدة الدودية؛ 5- الجهاز اللمفاوي للدقاق: أ- رقعة باير، ب- الجريبات الانفرادية.
يتعرف جهاز المناعة في الجسم على الأجسام والمواد الغريبة ويعالجها ويزيلها، ويوحد الأعضاء والأنسجة التي تحمي الجسم من الأمراض. أرز. 1 الأعضاء المركزية 1-نخاع العظم الأحمر (المشاشية عظم الفخذ); 2- الغدة الصعترية (الغدة الصعترية) الشكل 2. 2 الأجهزة الطرفية 1-الحلقة اللمفاوية الظهارية لبيروجوف (اللوزتين): أ - البلعوم، ج - الحنكي، ب - البوق، د - اللسان؛ 2- الطحال. 3- العقد الليمفاوية؛ 4- الزائدة الدودية؛ 5- الجهاز اللمفاوي للدقاق: أ- رقعة باير، ب- الجريبات الانفرادية.
 أعضاء الجهاز المناعي: النخاع العظمي الأحمر المركزي، الغدة الصعترية الطرفية، الغدة الطحالية، العقد الليمفاوية، المجموعات اللمفاوية في الأمعاء، الزائدة الدودية للأعور الأمعاء الدقيقةتراكمات اللمفاوية في الجهاز التنفسي حلقة بيروجوف اللمفاوية الظهارية
أعضاء الجهاز المناعي: النخاع العظمي الأحمر المركزي، الغدة الصعترية الطرفية، الغدة الطحالية، العقد الليمفاوية، المجموعات اللمفاوية في الأمعاء، الزائدة الدودية للأعور الأمعاء الدقيقةتراكمات اللمفاوية في الجهاز التنفسي حلقة بيروجوف اللمفاوية الظهارية
 نخاع العظم (medulla ossium) هو العضو الرئيسي في تكون الدم، ويبلغ إجمالي كتلة نخاع العظم 1.5 كجم. الموقع: عند الأطفال حديثي الولادة يملأ جميع تجاويف النخاع العظمي، بعد 4-5 سنوات في الجسم. العظام الأنبوبيةيتم استبدال نخاع العظم الأحمر بالأنسجة الدهنية ويكتسب لونًا أصفر. عند البالغين، يتم تخزين نخاع العظم الأحمر في المشاشات للعظام الطويلة والعظام القصيرة والعظام المسطحة. البنية: يتكون نخاع العظم الأحمر من الأنسجة النخاعية، التي تحتوي على الخلايا الجذعية المكونة للدم، وهي أسلاف جميع العناصر المكونة للدم. تدخل بعض الخلايا الجذعية إلى الغدة الصعترية، حيث تتمايز إلى خلايا ليمفاوية تائية، أي أنها تعتمد على الغدة الصعترية، وتقوم بتدمير الخلايا المتقادمة أو الخبيثة، كما تدمر الخلايا الأجنبية أيضًا، أي أنها توفر مناعة خلوية ونسيجية. يتمايز الجزء المتبقي من الخلايا الجذعية كخلايا تشارك في التفاعلات الخلطية للجهاز المناعي، أي الخلايا الليمفاوية البائية، أو التي تعتمد على الجراب، فهي مؤسسو الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة، أو الغلوبولين المناعي. وظائف نخاع العظم الأحمر: 1. المكونة للدم 2. المناعية (تمايز الخلايا الليمفاوية البائية)
نخاع العظم (medulla ossium) هو العضو الرئيسي في تكون الدم، ويبلغ إجمالي كتلة نخاع العظم 1.5 كجم. الموقع: عند الأطفال حديثي الولادة يملأ جميع تجاويف النخاع العظمي، بعد 4-5 سنوات في الجسم. العظام الأنبوبيةيتم استبدال نخاع العظم الأحمر بالأنسجة الدهنية ويكتسب لونًا أصفر. عند البالغين، يتم تخزين نخاع العظم الأحمر في المشاشات للعظام الطويلة والعظام القصيرة والعظام المسطحة. البنية: يتكون نخاع العظم الأحمر من الأنسجة النخاعية، التي تحتوي على الخلايا الجذعية المكونة للدم، وهي أسلاف جميع العناصر المكونة للدم. تدخل بعض الخلايا الجذعية إلى الغدة الصعترية، حيث تتمايز إلى خلايا ليمفاوية تائية، أي أنها تعتمد على الغدة الصعترية، وتقوم بتدمير الخلايا المتقادمة أو الخبيثة، كما تدمر الخلايا الأجنبية أيضًا، أي أنها توفر مناعة خلوية ونسيجية. يتمايز الجزء المتبقي من الخلايا الجذعية كخلايا تشارك في التفاعلات الخلطية للجهاز المناعي، أي الخلايا الليمفاوية البائية، أو التي تعتمد على الجراب، فهي مؤسسو الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة، أو الغلوبولين المناعي. وظائف نخاع العظم الأحمر: 1. المكونة للدم 2. المناعية (تمايز الخلايا الليمفاوية البائية)
 الغدة الزعترية(الغدة الصعترية) وهي العضو المركزي في جهاز المناعة وعضو في جهاز الغدد الصماء. تبلغ كتلة العضو خلال فترة النمو الأقصى (10-15 سنة) 30-40 جم، ثم تخضع الغدة للارتداد ويتم استبدالها بالأنسجة الدهنية. موقع: المنصف الأمامي. البنية: 1. المادة القشرية، وفيها تتمايز الخلايا اللمفاوية التائية غير الناضجة (المساعدة، القاتلة، المثبطة، الذاكرة)، ثم تدخل إلى الأعضاء الطرفية لجهاز المناعة (العقد الليمفاوية، الطحال، اللوزتين)، حيث توفر الاستجابة المناعية للجسم. 2. النخاع، الذي ينتج هرموني الثيموسين والثيموبويتين، اللذين ينظمان عمليات النمو والنضج والتمايز للخلايا التائية والنشاط الوظيفي للخلايا الناضجة في الجهاز المناعي. وظائف الغدة الصعترية: 1. المناعية 1- الغضروف الدرقي؛ 2- الغدة الدرقية (تمايز الخلايا اللمفاوية التائية). غدة؛ 3 - القصبة الهوائية. 4 - الرئة اليمنى; 2. الغدد الصماء (الغدة الصماء، 5 - الرئة اليسرى؛ 6 - الشريان الأورطي؛ 7 - الغدة الصعترية تنتج الهرمونات: الثيموسين، الثيموبويتين). غدة؛ 8 - كيس التامور
الغدة الزعترية(الغدة الصعترية) وهي العضو المركزي في جهاز المناعة وعضو في جهاز الغدد الصماء. تبلغ كتلة العضو خلال فترة النمو الأقصى (10-15 سنة) 30-40 جم، ثم تخضع الغدة للارتداد ويتم استبدالها بالأنسجة الدهنية. موقع: المنصف الأمامي. البنية: 1. المادة القشرية، وفيها تتمايز الخلايا اللمفاوية التائية غير الناضجة (المساعدة، القاتلة، المثبطة، الذاكرة)، ثم تدخل إلى الأعضاء الطرفية لجهاز المناعة (العقد الليمفاوية، الطحال، اللوزتين)، حيث توفر الاستجابة المناعية للجسم. 2. النخاع، الذي ينتج هرموني الثيموسين والثيموبويتين، اللذين ينظمان عمليات النمو والنضج والتمايز للخلايا التائية والنشاط الوظيفي للخلايا الناضجة في الجهاز المناعي. وظائف الغدة الصعترية: 1. المناعية 1- الغضروف الدرقي؛ 2- الغدة الدرقية (تمايز الخلايا اللمفاوية التائية). غدة؛ 3 - القصبة الهوائية. 4 - الرئة اليمنى; 2. الغدد الصماء (الغدة الصماء، 5 - الرئة اليسرى؛ 6 - الشريان الأورطي؛ 7 - الغدة الصعترية تنتج الهرمونات: الثيموسين، الثيموبويتين). غدة؛ 8 - كيس التامور
 الطحال (الطحال) هو أكبر عضو في الجهاز المناعي، يصل طوله إلى 12 سم، ووزنه 150-200 جرام الموقع: في المراق الأيسر، يتميز بلون أحمر بني مميز، وممدود مسطح. الشكل والاتساق الناعم. وهو مغطى من الأعلى بغشاء ليفي يندمج مع الغشاء المصلي (البريتوني)، وموقعه داخل الصفاق. الهيكل: 1. الأسطح - الحجاب الحاجز والحشوي. 2. بوابة الطحال – تقع في وسط السطح الحشوي – مكان اختراق الأوعية (الشريان والوريد الطحالي) والأعصاب التي تغذي العضو وتعصبه. 3. حمة الطحال - اللب الأبيض (اللب)، الذي يتكون من الجريبات اللمفاوية من الطحال واللب الأحمر، وتشكل 75-85٪ من الكتلة الإجمالية للعضو، والتي تتكون من الجيوب الوريدية، وخلايا الدم الحمراء، والخلايا الليمفاوية وغيرها من الخلايا عناصر. وظائف الطحال: 1. تدمير خلايا الدم الحمراء التي انتهت دورة الحياة. 2. المناعية (التمايز بين الخلايا الليمفاوية B و T). 3. مستودع الدم. 1 - سطح الحجاب الحاجز. 2 - الحافة العلوية; 3 - بوابة الطحال. 4 - الشريان الطحالي. 5 - الوريد الطحالي. 6 - الحافة السفلية. 7 - السطح الحشوي 1 - الغشاء الليفي. 2 - التربيق الطحالي. 3 - البصيلات اللمفاويةطحال؛ 4 - الجيوب الوريدية. 5 - اللب الأبيض. 6- اللب الأحمر
الطحال (الطحال) هو أكبر عضو في الجهاز المناعي، يصل طوله إلى 12 سم، ووزنه 150-200 جرام الموقع: في المراق الأيسر، يتميز بلون أحمر بني مميز، وممدود مسطح. الشكل والاتساق الناعم. وهو مغطى من الأعلى بغشاء ليفي يندمج مع الغشاء المصلي (البريتوني)، وموقعه داخل الصفاق. الهيكل: 1. الأسطح - الحجاب الحاجز والحشوي. 2. بوابة الطحال – تقع في وسط السطح الحشوي – مكان اختراق الأوعية (الشريان والوريد الطحالي) والأعصاب التي تغذي العضو وتعصبه. 3. حمة الطحال - اللب الأبيض (اللب)، الذي يتكون من الجريبات اللمفاوية من الطحال واللب الأحمر، وتشكل 75-85٪ من الكتلة الإجمالية للعضو، والتي تتكون من الجيوب الوريدية، وخلايا الدم الحمراء، والخلايا الليمفاوية وغيرها من الخلايا عناصر. وظائف الطحال: 1. تدمير خلايا الدم الحمراء التي انتهت دورة الحياة. 2. المناعية (التمايز بين الخلايا الليمفاوية B و T). 3. مستودع الدم. 1 - سطح الحجاب الحاجز. 2 - الحافة العلوية; 3 - بوابة الطحال. 4 - الشريان الطحالي. 5 - الوريد الطحالي. 6 - الحافة السفلية. 7 - السطح الحشوي 1 - الغشاء الليفي. 2 - التربيق الطحالي. 3 - البصيلات اللمفاويةطحال؛ 4 - الجيوب الوريدية. 5 - اللب الأبيض. 6- اللب الأحمر
 العقدة الليمفاوية هي الأعضاء الطرفية الأكثر عددًا في الجهاز المناعي (500 - 700)، وتقع على طريق التدفق الليمفاوي من الأعضاء والأنسجة إلى القنوات اللمفاوية والجذوع. وظائف العقدة الليمفاوية: 1. وظيفة الحاجز الوقائي (البلعمة) 2. المناعية (النضج والتمايز وتكاثر الخلايا الليمفاوية التائية والبائية) الهيكل: 1 - الأوعية اللمفاوية الواردة. 2 - الأوعية اللمفاوية الصادرة. 3 - القشرة. 4 - الشريان. 5 - الوريد. 6 - كبسولة. 7 - النخاع. 8 - بوابة العقدة الليمفاوية. 9 - الترابيق. 10 - العقدة الليمفاوية
العقدة الليمفاوية هي الأعضاء الطرفية الأكثر عددًا في الجهاز المناعي (500 - 700)، وتقع على طريق التدفق الليمفاوي من الأعضاء والأنسجة إلى القنوات اللمفاوية والجذوع. وظائف العقدة الليمفاوية: 1. وظيفة الحاجز الوقائي (البلعمة) 2. المناعية (النضج والتمايز وتكاثر الخلايا الليمفاوية التائية والبائية) الهيكل: 1 - الأوعية اللمفاوية الواردة. 2 - الأوعية اللمفاوية الصادرة. 3 - القشرة. 4 - الشريان. 5 - الوريد. 6 - كبسولة. 7 - النخاع. 8 - بوابة العقدة الليمفاوية. 9 - الترابيق. 10 - العقدة الليمفاوية
 التراكمات اللمفاوية في الجهاز التنفسي، اللوزتين عبارة عن تراكمات كبيرة من الأنسجة اللمفاوية: 1 - عند جذر اللسان - لساني، 2 - بين الأقواس الأمامية والخلفية للحنك الرخو - الحنكي، 3 - على الجدار الخلفي العلوي البلعوم الأنفي - البلعومي 4 - في منطقة قناة استاكيوس - الأنبوب تشكل الأنسجة اللمفاوية المنتشرة في منطقة الغشاء المخاطي البلعومي مع اللوزتين حاجزًا وقائيًا يسمى حلقة بيروجوف اللمفاوية البلعومية. في الأمعاء في الغشاء المخاطي للأمعاء - تراكمات الأنسجة اللمفاوية الظهارية: الأمعاء الدقيقة 1 - مجموعة البصيلات اللمفاوية (بقع باير) - اللفائفي. 2 - بصيلات واحدة (الانفرادية) - الصائم. الأمعاء الغليظة 3 – التكوينات اللمفاوية – الجدار الزائدة الدودية(زائدة).
التراكمات اللمفاوية في الجهاز التنفسي، اللوزتين عبارة عن تراكمات كبيرة من الأنسجة اللمفاوية: 1 - عند جذر اللسان - لساني، 2 - بين الأقواس الأمامية والخلفية للحنك الرخو - الحنكي، 3 - على الجدار الخلفي العلوي البلعوم الأنفي - البلعومي 4 - في منطقة قناة استاكيوس - الأنبوب تشكل الأنسجة اللمفاوية المنتشرة في منطقة الغشاء المخاطي البلعومي مع اللوزتين حاجزًا وقائيًا يسمى حلقة بيروجوف اللمفاوية البلعومية. في الأمعاء في الغشاء المخاطي للأمعاء - تراكمات الأنسجة اللمفاوية الظهارية: الأمعاء الدقيقة 1 - مجموعة البصيلات اللمفاوية (بقع باير) - اللفائفي. 2 - بصيلات واحدة (الانفرادية) - الصائم. الأمعاء الغليظة 3 – التكوينات اللمفاوية – الجدار الزائدة الدودية(زائدة).
 المناعة هي مجموعة من الخصائص الوقائية للجسم التي تهدف إلى الحفاظ على سلامته البيولوجية وفرديته من العدوى الخارجية (البكتيريا والفيروسات والأوالي)، من الخلايا المتغيرة والميتة. تصنيف المناعة طبيعية: - خلقية (من الأم إلى الجنين) - مكتسبة (بعد المرض) اصطناعية: - نشطة (اللقاحات) - سلبية (أمصال) خلوية (البلعمة) محددة (تدمير عامل ممرض محدد) خلطية (الجلوبيولين المناعي) غير محددة (يمنع الجميع من دخول مسببات الأمراض إلى الجسم)
المناعة هي مجموعة من الخصائص الوقائية للجسم التي تهدف إلى الحفاظ على سلامته البيولوجية وفرديته من العدوى الخارجية (البكتيريا والفيروسات والأوالي)، من الخلايا المتغيرة والميتة. تصنيف المناعة طبيعية: - خلقية (من الأم إلى الجنين) - مكتسبة (بعد المرض) اصطناعية: - نشطة (اللقاحات) - سلبية (أمصال) خلوية (البلعمة) محددة (تدمير عامل ممرض محدد) خلطية (الجلوبيولين المناعي) غير محددة (يمنع الجميع من دخول مسببات الأمراض إلى الجسم)

 ايليا متشنيكوف - مؤسس النظرية المناعة الخلويةاكتشف ظاهرة البلعمة - التقاط وتدمير الميكروبات والجزيئات البيولوجية الأخرى الغريبة عن الجسم بواسطة خلايا خاصة. ولاحظ أنه إذا كان الجسم الغريب صغيرًا بدرجة كافية، فإن الخلايا المتجولة، والتي أطلق عليها اسم الخلايا البالعة من الكلمة اليونانية phagein ("لتناول الطعام")، يمكن أن تبتلع الكائن الفضائي بالكامل. ويعتقد متشنيكوف أن هذه الآلية هي الآلية الرئيسية في جهاز المناعة. إن الخلايا البالعة هي التي تندفع للهجوم مسببة رد فعل التهابي، على سبيل المثال، عن طريق الحقن، أو الشظية، وما إلى ذلك. بول إرليخ - مؤسس النظرية الحصانة الخلطيةوأثبت العكس. الدور الرئيسي في الحماية من العدوى لا ينتمي إلى الخلايا، بل إلى الأجسام المضادة التي تكتشفها - وهي جزيئات محددة تتشكل في مصل الدم استجابةً لإدخال المعتدي. في عام 1891، أطلق إيرليك على المواد المضادة للميكروبات في الدم مصطلح "الجسم المضاد" (باللغة الألمانية antikorper)، حيث كانت البكتيريا في ذلك الوقت تسمى مصطلح "korper" - الأجسام المجهرية. بول إيرليك 1854 -1915 ومن المثير للاهتمام أن المنافسين العلميين غير القابلين للتوفيق - آي. ميتشنيكوف وبي. إيرليك - تقاسموا جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 1908 لعملهم في مجال علم المناعة.
ايليا متشنيكوف - مؤسس النظرية المناعة الخلويةاكتشف ظاهرة البلعمة - التقاط وتدمير الميكروبات والجزيئات البيولوجية الأخرى الغريبة عن الجسم بواسطة خلايا خاصة. ولاحظ أنه إذا كان الجسم الغريب صغيرًا بدرجة كافية، فإن الخلايا المتجولة، والتي أطلق عليها اسم الخلايا البالعة من الكلمة اليونانية phagein ("لتناول الطعام")، يمكن أن تبتلع الكائن الفضائي بالكامل. ويعتقد متشنيكوف أن هذه الآلية هي الآلية الرئيسية في جهاز المناعة. إن الخلايا البالعة هي التي تندفع للهجوم مسببة رد فعل التهابي، على سبيل المثال، عن طريق الحقن، أو الشظية، وما إلى ذلك. بول إرليخ - مؤسس النظرية الحصانة الخلطيةوأثبت العكس. الدور الرئيسي في الحماية من العدوى لا ينتمي إلى الخلايا، بل إلى الأجسام المضادة التي تكتشفها - وهي جزيئات محددة تتشكل في مصل الدم استجابةً لإدخال المعتدي. في عام 1891، أطلق إيرليك على المواد المضادة للميكروبات في الدم مصطلح "الجسم المضاد" (باللغة الألمانية antikorper)، حيث كانت البكتيريا في ذلك الوقت تسمى مصطلح "korper" - الأجسام المجهرية. بول إيرليك 1854 -1915 ومن المثير للاهتمام أن المنافسين العلميين غير القابلين للتوفيق - آي. ميتشنيكوف وبي. إيرليك - تقاسموا جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 1908 لعملهم في مجال علم المناعة.
 مخطط البلعمة البلعمة. تتكون عملية البلعمة من المراحل التالية: 1. الانجذاب الكيميائي - تقدم الخلية البلعمية إلى موضع البلعمة. 2. الالتصاق (المرفق). 3. يحتوي غشاء الخلايا البالعة على مستقبلات مختلفة لالتقاط الكائنات الحية الدقيقة. 4. الالتقام (الامتصاص). 5. يتم غمر الجزيئات التي تم التقاطها في البروتوبلازم ونتيجة لذلك يتكون البلعم مع جسم محاصر بالداخل. 6. تندفع الجسيمات الحالة إلى الجسم البلعمي، ثم تندمج قذائف الجسم البلعمي والجسيمات الحالة في الجسم البلعمي. 7. تتعرض الكائنات الحية الدقيقة الملتهمة للهجوم من قبل مجموعة من العوامل المبيدة للميكروبات المختلفة.
مخطط البلعمة البلعمة. تتكون عملية البلعمة من المراحل التالية: 1. الانجذاب الكيميائي - تقدم الخلية البلعمية إلى موضع البلعمة. 2. الالتصاق (المرفق). 3. يحتوي غشاء الخلايا البالعة على مستقبلات مختلفة لالتقاط الكائنات الحية الدقيقة. 4. الالتقام (الامتصاص). 5. يتم غمر الجزيئات التي تم التقاطها في البروتوبلازم ونتيجة لذلك يتكون البلعم مع جسم محاصر بالداخل. 6. تندفع الجسيمات الحالة إلى الجسم البلعمي، ثم تندمج قذائف الجسم البلعمي والجسيمات الحالة في الجسم البلعمي. 7. تتعرض الكائنات الحية الدقيقة الملتهمة للهجوم من قبل مجموعة من العوامل المبيدة للميكروبات المختلفة.
 معالم في تطور علم المناعة 1796 1861 1882 1886 1890 1901 1908 E. Jenner طريقة الحماية ضد الجدري L. Pasteur مبدأ إنشاء اللقاحات I. Mechnikov نظرية البلعمة للمناعة P. نظرية إرليخ الخلطية للمناعة Behring، Kitazato اكتشاف الأجسام المضادة K اكتشاف لاندشتاينر لفصائل الدم وبنية المستضدات ميتشنيكوف وإرليخ جائزة نوبللنظرية المناعة 1913 سي. ريتشيت اكتشاف الحساسية المفرطة 1919 جي بورديت اكتشاف المجاملة 1964 ف. بيرنت 1972 1980 نظرية الانتقاء النسيلي للمناعة جي. إديلشان فك بنية الأجسام المضادة ب. بيناسيراف اكتشاف التوافق النسيجي
معالم في تطور علم المناعة 1796 1861 1882 1886 1890 1901 1908 E. Jenner طريقة الحماية ضد الجدري L. Pasteur مبدأ إنشاء اللقاحات I. Mechnikov نظرية البلعمة للمناعة P. نظرية إرليخ الخلطية للمناعة Behring، Kitazato اكتشاف الأجسام المضادة K اكتشاف لاندشتاينر لفصائل الدم وبنية المستضدات ميتشنيكوف وإرليخ جائزة نوبللنظرية المناعة 1913 سي. ريتشيت اكتشاف الحساسية المفرطة 1919 جي بورديت اكتشاف المجاملة 1964 ف. بيرنت 1972 1980 نظرية الانتقاء النسيلي للمناعة جي. إديلشان فك بنية الأجسام المضادة ب. بيناسيراف اكتشاف التوافق النسيجي
 الإجهاد من اللغة الإنجليزية الإجهاد - التوتر الإجهاد هو رد فعل غير محدد (عام) لتوتر الكائن الحي لأي تأثير قوي يمارس عليه. هناك: الضغوط البشرية، والعصبية، والحرارية، والضوئية وغيرها، بالإضافة إلى الأشكال الإيجابية (الإجهاد) والسلبية (الضيق). قام الباحث الشهير في مجال الإجهاد، عالم وظائف الأعضاء الكندي هانز سيلي، بنشر أول عمل له عن متلازمة التكيف العامة في عام 1936، ولكن منذ وقت طويلتجنب استخدام مصطلح "الإجهاد"، لأنه كان يستخدم إلى حد كبير للإشارة إلى التوتر "العصبي" (متلازمة "القتال أو الهروب"). لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1946 عندما بدأ سيلي في استخدام مصطلح "الإجهاد" بشكل منهجي للإشارة إلى التوتر التكيفي العام. ولفت سيلي الانتباه إلى حقيقة أن بداية ظهور أي عدوى هي نفسها (الحمى والضعف وفقدان الشهية). في هذه الحقيقة المعروفة بشكل عام، رأى خاصية خاصة - عالمية، عدم خصوصية الاستجابة لأي ضرر. أظهرت التجارب على الفئران أنها تعطي نفس رد الفعل لكل من التسمم والحرارة أو البرودة. وقد وجد باحثون آخرون رد فعل مماثل لدى الأشخاص الذين أصيبوا بحروق شديدة.
الإجهاد من اللغة الإنجليزية الإجهاد - التوتر الإجهاد هو رد فعل غير محدد (عام) لتوتر الكائن الحي لأي تأثير قوي يمارس عليه. هناك: الضغوط البشرية، والعصبية، والحرارية، والضوئية وغيرها، بالإضافة إلى الأشكال الإيجابية (الإجهاد) والسلبية (الضيق). قام الباحث الشهير في مجال الإجهاد، عالم وظائف الأعضاء الكندي هانز سيلي، بنشر أول عمل له عن متلازمة التكيف العامة في عام 1936، ولكن منذ وقت طويلتجنب استخدام مصطلح "الإجهاد"، لأنه كان يستخدم إلى حد كبير للإشارة إلى التوتر "العصبي" (متلازمة "القتال أو الهروب"). لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1946 عندما بدأ سيلي في استخدام مصطلح "الإجهاد" بشكل منهجي للإشارة إلى التوتر التكيفي العام. ولفت سيلي الانتباه إلى حقيقة أن بداية ظهور أي عدوى هي نفسها (الحمى والضعف وفقدان الشهية). في هذه الحقيقة المعروفة بشكل عام، رأى خاصية خاصة - عالمية، عدم خصوصية الاستجابة لأي ضرر. أظهرت التجارب على الفئران أنها تعطي نفس رد الفعل لكل من التسمم والحرارة أو البرودة. وقد وجد باحثون آخرون رد فعل مماثل لدى الأشخاص الذين أصيبوا بحروق شديدة.
 مراحل التوتر المرحلة 1. رد فعل القلق. يستخدم الجسم جميع دفاعاته. هذه الحالة نموذجية لكثير من الأشخاص قبل الامتحان أو الاجتماع المهم أو العملية. في هذه المرحلة، يتم تنشيط أنظمة الغدة الكظرية الودية وتحت المهاد والغدة النخامية والكظرية والرينين أنجيوتنسين والألدوستيرون في جسم الإنسان. هناك زيادة في إنتاج الأدرينالين والنورإبينفرين، وزيادة في قشرة الغدة الكظرية. الاضطرابات المحتملة لنشاط القلب والأوعية الدموية - احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم. المرحلة 2. مرحلة التكيف. من خلال مكافحة الإجهاد والتكيف معه بشكل فعال، يظل الجسم في حالة من التوتر والتعبئة. الجسم وعامل التوتر يتعايشان معًا في المعارضة. خلال هذه الفترة، تنتج قشرة الغدة الكظرية الجلايكورتيكويدات بشكل مكثف بشكل خاص، مما قد يؤدي إلى القرحة الهضميةالمعدة و الاثنا عشري. تنشيط تنشيط منطقة ما تحت المهاد نظام الغدد الصماءتنشيط NS الودي الكاتيكولامينات الكظرية الجلايكورتيكويدات المرحلة 3. مرحلة الإرهاق. يؤدي البقاء في حالة مرهقة باستمرار والمقاومة طويلة الأمد للإجهاد إلى حقيقة أن احتياطيات الجسم تنتهي تدريجياً. يتطور الإرهاق. هذه المرحلة انتقالية لتطور العمليات المرضية وتتميز باضطراب في آليات الجهاز العصبي و التنظيم الخلطي. استنفاد قشرة الغدة الكظرية (قصور الغدة الكظرية المزمن).
مراحل التوتر المرحلة 1. رد فعل القلق. يستخدم الجسم جميع دفاعاته. هذه الحالة نموذجية لكثير من الأشخاص قبل الامتحان أو الاجتماع المهم أو العملية. في هذه المرحلة، يتم تنشيط أنظمة الغدة الكظرية الودية وتحت المهاد والغدة النخامية والكظرية والرينين أنجيوتنسين والألدوستيرون في جسم الإنسان. هناك زيادة في إنتاج الأدرينالين والنورإبينفرين، وزيادة في قشرة الغدة الكظرية. الاضطرابات المحتملة لنشاط القلب والأوعية الدموية - احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم. المرحلة 2. مرحلة التكيف. من خلال مكافحة الإجهاد والتكيف معه بشكل فعال، يظل الجسم في حالة من التوتر والتعبئة. الجسم وعامل التوتر يتعايشان معًا في المعارضة. خلال هذه الفترة، تنتج قشرة الغدة الكظرية الجلايكورتيكويدات بشكل مكثف بشكل خاص، مما قد يؤدي إلى القرحة الهضميةالمعدة و الاثنا عشري. تنشيط تنشيط منطقة ما تحت المهاد نظام الغدد الصماءتنشيط NS الودي الكاتيكولامينات الكظرية الجلايكورتيكويدات المرحلة 3. مرحلة الإرهاق. يؤدي البقاء في حالة مرهقة باستمرار والمقاومة طويلة الأمد للإجهاد إلى حقيقة أن احتياطيات الجسم تنتهي تدريجياً. يتطور الإرهاق. هذه المرحلة انتقالية لتطور العمليات المرضية وتتميز باضطراب في آليات الجهاز العصبي و التنظيم الخلطي. استنفاد قشرة الغدة الكظرية (قصور الغدة الكظرية المزمن).
 أمراض التكيف نظام القلب والأوعية الدموية: احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب الإقفارية، وارتفاع ضغط الدم. الجهاز الهضمي: قرحة المعدة والاثني عشر. أمراض التكيف الجلد: التهاب الجلد، الأكزيما، الصدفية، الشرى. الجهاز المناعي: الجهاز التنفسي: انخفاض المناعة. الربو القصبي
أمراض التكيف نظام القلب والأوعية الدموية: احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب الإقفارية، وارتفاع ضغط الدم. الجهاز الهضمي: قرحة المعدة والاثني عشر. أمراض التكيف الجلد: التهاب الجلد، الأكزيما، الصدفية، الشرى. الجهاز المناعي: الجهاز التنفسي: انخفاض المناعة. الربو القصبي
 نمط الاستجابة للتوتر والألم. نزيف الصدمة النفسية ارتفاع الحرارة تحت المهاد نظام الغدة النخامية الكظرية Liberins الجلوكوكورتيكويدات من قشرة الغدة الكظرية نظام رينين أنجيوتنسينالدوستيرون تنشيط خلايا NS JUGA الودية KA للغدد الكظرية رينين فاسوبريسين (ADH) الهرمونات الاستوائية للغدة النخامية الأمامية ACTH الجهاز الكظري الودي TSH احتباس الماء زيادة في CV K يضيق الأوعية الدموية آل دوس هرمون الغدة الدرقية الغدة الدرقيةثالثا: أنجيوتنسين II غير النشط. زيادة في ضغط الدم
نمط الاستجابة للتوتر والألم. نزيف الصدمة النفسية ارتفاع الحرارة تحت المهاد نظام الغدة النخامية الكظرية Liberins الجلوكوكورتيكويدات من قشرة الغدة الكظرية نظام رينين أنجيوتنسينالدوستيرون تنشيط خلايا NS JUGA الودية KA للغدد الكظرية رينين فاسوبريسين (ADH) الهرمونات الاستوائية للغدة النخامية الأمامية ACTH الجهاز الكظري الودي TSH احتباس الماء زيادة في CV K يضيق الأوعية الدموية آل دوس هرمون الغدة الدرقية الغدة الدرقيةثالثا: أنجيوتنسين II غير النشط. زيادة في ضغط الدم



الشريحة 2
دور أساسيفي الحماية ضد العدوى، لا تلعب المناعة دورًا، بل آليات مختلفة للإزالة الميكانيكية للكائنات الحية الدقيقة (التطهير).في أعضاء الجهاز التنفسي، يكون هذا هو إنتاج الفاعل بالسطح والبلغم، وحركة المخاط بسبب حركات أهداب الظهارة الهدبية والسعال والعطس. في الأمعاء، هذا هو التمعج وإنتاج العصائر والمخاط (الإسهال بسبب العدوى، وما إلى ذلك) على الجلد، فهو تقشر مستمر وتجديد الظهارة. يتم تشغيل الجهاز المناعي عندما تفشل آليات التصفية.
الشريحة 3
ظهارة الهدبية
الشريحة 4
الشريحة 5
وظائف حاجز الجلد
الشريحة 6
وبالتالي، فمن أجل البقاء في جسم المضيف، يجب على الميكروب أن "يثبت" على السطح الظهاري (يطلق علماء المناعة وعلماء الأحياء الدقيقة على هذا الالتصاق، أي الإلتصاق). ويجب على الجسم أن يمنع الالتصاق باستخدام آليات التخليص. في حالة حدوث الالتصاق، قد يحاول الميكروب التوغل عميقًا في الأنسجة أو إلى مجرى الدم، حيث لا تعمل آليات الإزالة. ولهذه الأغراض تنتج الميكروبات إنزيمات تعمل على تدمير أنسجة العائل، وتختلف جميع الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض عن الكائنات الحية الدقيقة غير المسببة للأمراض في قدرتها على إنتاج مثل هذه الإنزيمات.
الشريحة 7
إذا فشلت إحدى آليات التطهير في التعامل مع العدوى، فإن الجهاز المناعي ينضم إلى المعركة.
الشريحة 8
الحماية المناعية المحددة وغير المحددة
يشير الدفاع النوعي إلى الخلايا الليمفاوية المتخصصة التي يمكنها محاربة مستضد واحد فقط. يمكن للعوامل المناعية غير المحددة، مثل الخلايا البالعة والخلايا القاتلة الطبيعية والمكملات (الإنزيمات الخاصة) مكافحة العدوى إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع دفاع محدد.
الشريحة 9
الشريحة 10
نظام كامل
الشريحة 11
يتكون الجهاز المناعي من: الخلايا المناعية، وعدد من العوامل الخلطية، والأعضاء المناعية (الغدة الصعترية، والطحال، والغدد الليمفاوية)، وكذلك تراكم الأنسجة اللمفاوية (الأكثر تمثيلا على نطاق واسع في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي).
الشريحة 12
تتواصل أعضاء المناعة مع بعضها البعض ومع أنسجة الجسم من خلال الأوعية اللمفاوية والجهاز الدوري.
الشريحة 13
هناك أربعة أنواع رئيسية من الحالات المرضية للجهاز المناعي: 1. تفاعلات فرط الحساسية، والتي تتجلى في شكل تلف الأنسجة المناعية؛ 2. أمراض المناعة الذاتية، تتطور نتيجة لذلك ردود الفعل المناعيةضد جسده؛ 3. 4- متلازمات نقص المناعة الناتجة عن عيوب خلقية أو مكتسبة في الاستجابة المناعية. الداء النشواني.
الشريحة 14
تفاعلات فرط الحساسية إن اتصال الجسم بمستضد لا يضمن فقط تطور استجابة مناعية وقائية، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاعلات تلحق الضرر بالأنسجة. يمكن أن تبدأ تفاعلات فرط الحساسية (تلف الأنسجة المناعية) عن طريق تفاعل مستضد مع جسم مضاد أو خلية آليات المناعة. يمكن أن ترتبط هذه التفاعلات ليس فقط مع المستضدات الخارجية، ولكن أيضًا مع المستضدات الداخلية.
الشريحة 15
يتم تصنيف أمراض فرط الحساسية على أساس الآليات المناعية المسببة لها.التصنيف هناك أربعة أنواع من تفاعلات فرط الحساسية: النوع الأول - الاستجابة المناعية تكون مصحوبة بإطلاق مواد فعالة في الأوعية ومولدة للتشنج. النوع الثاني - تشارك الأجسام المضادة في تلف الخلايا، مما يجعل هم عرضة للبلعمة أو التحلل النوع الثالث - تفاعل الأجسام المضادة مع المستضدات يؤدي إلى تكوين المجمعات المناعية التي تنشط المتممة. تجذب الأجزاء المتممة العدلات التي تلحق الضرر بالأنسجة؛ النوع الرابع - تتطور الاستجابة المناعية الخلوية بمشاركة الخلايا الليمفاوية الحساسة.
الشريحة 16
تفاعلات فرط الحساسية من النوع الأول (النوع الفوري، النوع التحسسي) يمكن أن تكون موضعية أو جهازية. الوريدالمستضد الذي كان الكائن الحي المضيف حساسًا له سابقًا وقد يكون له هذه الصفة صدمة الحساسيةردود الفعل المحلية تعتمد على موقع اختراق المستضد ولها طابع تورم محدود في الجلد ( حساسية الجلد، الشرى)، إفرازات الأنف والملتحمة ( التهاب الأنف التحسسي، التهاب الملتحمة)، حمى القش، الربو القصبي أو التهاب المعدة والأمعاء التحسسي (حساسية الطعام).
الشريحة 17
قشعريرة
الشريحة 18
تمر تفاعلات فرط الحساسية من النوع الأول بمرحلتين في تطورها - الاستجابة الأولية والمتأخرة: - تتطور مرحلة الاستجابة الأولية بعد 5-30 دقيقة من ملامسة مسبب الحساسية وتتميز بتوسع الأوعية وزيادة النفاذية وكذلك تشنج الملساء. إفراز العضلات أو الغدد - يتم ملاحظة الطور المتأخر بعد 2-8 ساعات دون اتصال إضافي مع المستضد، ويستمر عدة أيام ويتميز بتسلل الأنسجة المكثف بواسطة الحمضات والعدلات والقاعدات والوحيدات، بالإضافة إلى تلف الأنسجة. الخلايا الظهاريةالأغشية المخاطية. يتم ضمان تطور فرط الحساسية من النوع الأول عن طريق الأجسام المضادة IgE التي يتم تشكيلها استجابةً لمسببات الحساسية بمشاركة الخلايا المساعدة T2.
الشريحة 19
رد فعل فرط الحساسية من النوع الأول يكمن وراء تطور صدمة الحساسية. يحدث الحساسية المفرطة الجهازية بعد تناول البروتينات غير المتجانسة - الأمصال المضادة والهرمونات والإنزيمات والسكريات وبعض الأدوية (مثل البنسلين).
الشريحة 20
تفاعلات فرط الحساسية من النوع الثاني (فورية فرط الحساسية) ناتج عن الأجسام المضادة IgG لمستضدات خارجية ممتصة على الخلايا أو المصفوفة خارج الخلية. مع مثل هذه التفاعلات، تظهر الأجسام المضادة في الجسم موجهة ضد خلايا أنسجته. يمكن أن تتشكل المحددات المستضدية في الخلايا نتيجة لاضطرابات على مستوى الجينات، مما يؤدي إلى تخليق بروتينات غير نمطية، أو أنها تمثل مستضد خارجي ممتز على سطح الخلية أو المصفوفة خارج الخلية. على أي حال، يحدث تفاعل فرط الحساسية نتيجة لارتباط الأجسام المضادة بالهياكل الطبيعية أو التالفة للخلية أو المصفوفة خارج الخلية.
الشريحة 21
تفاعلات فرط الحساسية من النوع الثالث (تفاعل فرط الحساسية الفوري الناجم عن تفاعل الأجسام المضادة IgG ومستضد خارجي قابل للذوبان) يرجع تطور مثل هذه التفاعلات إلى وجود مجمعات الأجسام المضادة للمستضد التي تتشكل نتيجة ارتباط المستضد بالجسم المضاد في مجرى الدم (المجمعات المناعية المنتشرة) أو خارج الأوعية الموجودة على السطح أو داخل الهياكل الخلوية (أو خارج الخلية) (المجمعات المناعية في الموقع).
الشريحة 22
تتسبب المجمعات المناعية المنتشرة (CICs) في حدوث ضرر عند دخولها إلى جدار الأوعية الدموية أو هياكل الترشيح (المرشح الأنبوبي في الكلى). هناك نوعان معروفان من الأضرار المعقدة المناعية، والتي تتشكل عندما يدخل مستضد خارجي (بروتين أجنبي، بكتيريا، فيروس) إلى الجسم وعندما تتشكل الأجسام المضادة ضد المستضدات الخاصة بالشخص. يمكن أن تكون الأمراض الناجمة عن وجود معقدات مناعية عامة، إذا تشكلت هذه المجمعات في الدم واستقرت في العديد من الأعضاء، أو ارتبطت بأعضاء فردية، مثل الكلى (التهاب كبيبات الكلى)، المفاصل (التهاب المفاصل) أو الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد. .
الشريحة 23
الكلى مع التهاب كبيبات الكلى
الشريحة 24
مرض معقد مناعي جهازي ومن أصنافه داء المصل الحاد، والذي يحدث نتيجة التحصين السلبي الناتج عن التناول المتكرر لجرعات كبيرة من المصل الأجنبي.
الشريحة 25
يتطور مرض المصل المزمن مع الاتصال لفترة طويلة مع مستضد. تعد مستضدات الدم الثابتة ضرورية لتطور مرض معقد مناعي مزمن، حيث تستقر المجمعات المناعية في أغلب الأحيان سرير الأوعية الدموية. على سبيل المثال، يرتبط الذئبة الحمامية الجهازية باستمرار طويل الأمد للمستضدات الذاتية. في كثير من الأحيان، على الرغم من وجود مميزة التغيرات المورفولوجيةوغيرها من العلامات التي تشير إلى تطور مرض مناعي معقد، يبقى المستضد مجهولاً. هذه الظواهر نموذجية ل التهاب المفصل الروماتويدي، التهاب حوائط الشريان العقدي، اعتلال الكلية الغشائي وبعض التهابات الأوعية الدموية.
الشريحة 26
الذئبة الحمامية الجهازية
الشريحة 27
التهاب المفاصل الروماتويدي
الشريحة 28
التهاب الأوعية الدموية الجهازية
الشريحة 29
يتم التعبير عن مرض المعقد المناعي المحلي (رد فعل آرثوس) في نخر الأنسجة الموضعي الناتج عن التهاب الأوعية الدموية المعقد المناعي الحاد.
الشريحة 31
يتكون فرط الحساسية المتأخر (DTH) من عدة مراحل: 1 - الاتصال الأولي مع المستضد يضمن تراكم خلايا T مساعدة محددة؛ 2 - عند تناوله بشكل متكرر لنفس المستضد، يتم التقاطه بواسطة البلاعم الإقليمية، التي تعمل كمستضد. تقديم الخلايا، وإزالة شظايا المستضد من سطحها؛ 3 - تتفاعل الخلايا التائية المساعدة الخاصة بمستضد معين مع المستضد الموجود على سطح البلاعم وتفرز عددًا من السيتوكينات؛ 4- تفرز السيتوكينات لضمان تكوينها رد فعل التهابي، مصحوبًا بتراكم الخلايا الوحيدة/الضامة، التي تدمر منتجاتها الخلايا المضيفة القريبة.
الشريحة 32
عندما يستمر المستضد، تتحول الخلايا البلعمية إلى خلايا شبيهة بالظهارة محاطة بمجموعة من الخلايا الليمفاوية - ويتشكل الورم الحبيبي. هذا الالتهاب هو سمة من سمات فرط الحساسية من النوع الرابع ويسمى الورم الحبيبي.
الشريحة 33
الصورة النسيجية للأورام الحبيبية
مرض الساركويد. مرض السل
الشريحة 34
أمراض المناعة الذاتية الاضطرابات التسامح المناعييؤدي إلى رد فعل مناعي غريب لمستضدات الجسم - عدوان المناعة الذاتية وتشكيل حالة من المناعة الذاتية. عادة، يمكن العثور على الأجسام المضادة الذاتية في مصل الدم أو الأنسجة لدى العديد من الأشخاص الأصحاء، وخاصة في الفئة العمرية الأكبر سنا. وتتكون هذه الأجسام المضادة بعد تلف الأنسجة وتلعب دورًا فسيولوجيًا في إزالة بقاياها.
الشريحة 35
هناك ثلاث علامات رئيسية لأمراض المناعة الذاتية: - وجود رد فعل مناعي ذاتي؛ - وجود أدلة سريرية وتجريبية على أن مثل هذا التفاعل ليس ثانويًا لتلف الأنسجة، ولكن له أهمية إمراضيية أولية؛ - عدم وجود أسباب محددة أخرى من المرض.
الشريحة 36
وفي الوقت نفسه، هناك حالات يتم فيها توجيه عمل الأجسام المضادة ضد العضو أو الأنسجة، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة المحلية. على سبيل المثال، في التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو (تضخم الغدة الدرقية هاشيموتو)، تكون الأجسام المضادة محددة تمامًا للغدة الدرقية. في الذئبة الحمامية الجهازية، تتفاعل مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة الذاتية مع عناصرنواة الخلايا المختلفة، وفي متلازمة جودباستشر، تسبب الأجسام المضادة ضد الغشاء القاعدي للرئتين والكليتين ضررًا في هذه الأعضاء فقط. من الواضح أن المناعة الذاتية تعني ضمناً فقدان القدرة على تحمل الذات. والتسامح المناعي عبارة عن حالة لا تتطور فيها الاستجابة المناعية لمستضد معين.
الشريحة 37
متلازمات نقص المناعة نقص المناعة (نقص المناعة) هو حالة مرضية ناجمة عن نقص مكونات أو عوامل أو أجزاء من الجهاز المناعي مع انتهاكات حتمية للمراقبة المناعية و/أو الاستجابة المناعية لمستضد أجنبي.
الشريحة 38
تنقسم جميع حالات نقص المناعة إلى أولية (غالبًا ما تكون محددة وراثيًا) وثانوية (مرتبطة بمضاعفات الأمراض المعدية، واضطرابات التمثيل الغذائي، آثار جانبيةكبت المناعة، الإشعاع، العلاج الكيميائي للسرطان). نقص المناعة الأولية هو مجموعة غير متجانسة من الأمراض الخلقية المحددة وراثيا الناجمة عن ضعف التمايز ونضج الخلايا الليمفاوية التائية والبائية.
الشريحة 39
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 70 نقص المناعة الأولية. على الرغم من أن معظم حالات نقص المناعة نادرة جدًا، إلا أن بعضها (مثل نقص IgA) شائع جدًا، خاصة عند الأطفال.
الشريحة 40
نقص المناعة المكتسب (الثانوي) إذا أصبح نقص المناعة هو السبب الرئيسي لتطور الأمراض المعدية أو المعدية المستمرة أو المتكررة عملية الورم، يمكننا أن نتحدث عن متلازمة نقص المناعة الثانوية (نقص المناعة الثانوية).
الشريحة 41
متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بداية القرن الحادي والعشرين. يتم تسجيل مرض الإيدز في أكثر من 165 دولة حول العالم، وأكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) موجود في أفريقيا وآسيا. تم تحديد 5 مجموعات معرضة للخطر بين البالغين: - يشكل الرجال المثليون ومزدوجي التوجه الجنسي أكبر مجموعة (ما يصل إلى 60٪ من المرضى)؛ - الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الوريد (ما يصل إلى 23٪)؛ - مرضى الهيموفيليا (1%) - متلقي الدم ومكوناته (2%). - الاتصالات بين الجنسين بين أعضاء المجموعات الأخرى ارتفاع الخطرمدمني المخدرات بشكل رئيسي - (6٪). في حوالي 6% من الحالات، لم يتم تحديد عوامل الخطر. حوالي 2% من مرضى الإيدز هم من الأطفال.
الشريحة 42
المسببات: العامل المسبب لمرض الإيدز هو فيروس نقص المناعة البشرية، وهو فيروس قهقري من عائلة الفيروس البطيء. هناك نوعان وراثيا أشكال مختلفةالفيروس: فيروسات نقص المناعة البشرية 1 و2 (HIV-1 وHIV-2، أو فيروس نقص المناعة البشرية-1 وHIV-2). فيروس نقص المناعة البشرية (HIV-1) هو النوع الأكثر شيوعًا، ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا الوسطى وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV-2) - بشكل رئيسي في غرب أفريقيا.
الشريحة 43
هناك هدفان رئيسيان لفيروس نقص المناعة البشرية: الجهاز المناعي والجهاز المركزي الجهاز العصبي. يتميز التسبب المناعي لمرض الإيدز بتطور كبت مناعي عميق، والذي يرتبط بشكل أساسي بانخفاض واضح في عدد خلايا CD4 T. هناك الكثير من الأدلة على أن جزيء CD4 هو في الواقع مستقبل عالي الألفة لفيروس نقص المناعة البشرية. وهذا ما يفسر الانتحاء الانتقائي للفيروس بالنسبة لخلايا CD4 T.
الشريحة 44
يتكون مسار مرض الإيدز من ثلاث مراحل، تعكس ديناميكيات التفاعل بين الفيروس والمضيف: - المرحلة الحادة المبكرة، - المرحلة المزمنة المتوسطة، - ومرحلة الأزمة النهائية.
الشريحة 45
مرحلة حادة. تتطور الاستجابة الأولية للفرد ذو الكفاءة المناعية للفيروس. وتتميز هذه المرحلة مستوى عالتشكل الفيروس، وتفير الدم، وتلوث الأنسجة اللمفاوية على نطاق واسع، ولكن العدوى لا تزال تتم السيطرة عليها عن طريق الاستجابة المناعية المضادة للفيروسات.المرحلة المزمنة هي فترة الاحتواء النسبي للفيروس، عندما يكون الجهاز المناعي سليما، ولكن تكرار ضعيف للفيروس ويلاحظ الفيروس، وخاصة في الأنسجة اللمفاوية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة عدة سنوات، وتتميز المرحلة النهائية بالانتهاك الات دفاعيةالمضيف والتكاثر الفيروسي غير المنضبط. ينخفض محتوى خلايا CD4 T. وبعد فترة غير مستقرة تظهر التهابات انتهازية خطيرة وأورام ويتأثر الجهاز العصبي.
الشريحة 46
عدد الخلايا الليمفاوية CD4 ونسخ الحمض النووي الريبوزي (RNA) للفيروس في دم المريض منذ لحظة الإصابة حتى المرحلة النهائية. عدد الخلايا الليمفاوية CD4+ T (الخلايا/ مم3) عدد نسخ الحمض النووي الريبي الفيروسي لكل مل. بلازما
خطة المحاضرة الغرض: تعليم الطلاب فهم التنظيم الهيكلي والوظيفي لجهاز المناعة،
السمات الفطرية والتكيفية
حصانة.
1. مفهوم علم المناعة كموضوع أساسي
مراحل تطورها.
2. .
3 أنواع المناعة: السمات الفطرية و
حصانة التكيفية.
4. خصائص الخلايا المشاركة في التفاعلات
المناعة الفطرية والتكيفية.
5. هيكل الأجهزة المركزية والمحيطية
وظائف الجهاز المناعي.
6. الأنسجة اللمفاوية: البنية والوظيفة.
7. جلاكسو سميث كلاين.
8. الخلايا الليمفاوية – الوحدة الهيكلية والوظيفية
الجهاز المناعي.
عدد الخلايا - أنواع الخلايا ذات العدد الأكبر
الخصائص العامة
السكان الفرعي للخلايا - أكثر تخصصا
خلايا متجانسة
السيتوكينات – وسطاء الببتيد القابلة للذوبان
جهاز المناعة الضروري لتطوره ،
الأداء والتفاعل مع الآخرين
أنظمة الجسم.
الخلايا المناعية (ICC) - الخلايا
ضمان أداء الوظائف المناعية
أنظمة
علم المناعة
- علم المناعة الذيهيكل الدراسات ووظيفتها
جهاز المناعة في الجسم
الشخص كما هو الحال في الظروف العادية،
وكذلك في المرضية
تنص على.
دراسات المناعة:
هيكل الجهاز المناعي وآلياتهتطوير ردود الفعل المناعية
أمراض الجهاز المناعي واختلال وظائفه
ظروف وأنماط التنمية
التفاعلات المرضية المناعية وطرق التعامل معها
التصحيحات
إمكانية استخدام الاحتياطيات و
آليات عمل الجهاز المناعي في مكافحة
المعدية والأورام وما إلى ذلك.
الأمراض
المشاكل المناعية للزرع
الأعضاء والأنسجة، والتكاثر
المراحل الرئيسية في تطور علم المناعة
باستور ل. (1886) - اللقاحات (الوقاية من الأمراض المعديةالأمراض)
Bering E., Ehrlich P. (1890) - وضع الأساس للخلطية
المناعة (اكتشاف الأجسام المضادة)
ميتشنيكوف آي. (1901-1908) - نظرية البلعمة
بورديت ج. (1899) – اكتشاف النظام المكمل
Richet S., Portier P. (1902) - اكتشاف الحساسية المفرطة
بيرك ك. (1906) – عقيدة الحساسية
لاندشتاينر ك. (1926) – اكتشاف فصائل الدم AB0 وعامل Rh
مدوفار (1940-1945) - عقيدة التسامح المناعي
Dosse J.، Snell D. (1948) - وضع أسس علم الوراثة المناعية
ميلر د.، كلامان ج.، ديفيس، رويت (1960) - عقيدة T- وB
اجهزة المناعة
دوموند (1968-1969) – مكتشف اللمفوكينات
كولر، ميلشتاين (1975) - طريقة للحصول على وحيدة النسيلة
الأجسام المضادة (الأورام الهجينة)
1980-2010 - تطوير طرق التشخيص والعلاج
علم الأمراض المناعية
حصانة
- وسيلة لحماية الجسم من الأجسام الحية والمواد التي تحمل الصفات الوراثية
المعلومات الأجنبية (بما في ذلك
الكائنات الحية الدقيقة والخلايا الأجنبية،
الأنسجة أو المعدلة وراثيا
الخلايا الخاصة، بما في ذلك الخلايا السرطانية)
أنواع المناعة
المناعة الفطرية وراثيةنظام الدفاع الثابت للكائنات متعددة الخلايا
الكائنات الحية من المسببة للأمراض وغير المسببة للأمراض
الكائنات الحية الدقيقة، وكذلك المنتجات الداخلية
تدمير الأنسجة.
تتشكل المناعة المكتسبة (التكيفية) طوال الحياة تحت تأثير
التحفيز المستضدي.
المناعة الفطرية والمكتسبة هي
جزأين متفاعلين من الجهاز المناعي
الأنظمة التي تضمن تطور الجهاز المناعي
الاستجابة للمواد الغريبة وراثيا. المناعة الجهازية – على المستوى
الجسم كله
المناعة المحلية -
مستوى إضافي من الحماية
الأقمشة العازلة ( جلدو
الأغشية المخاطية)
التنظيم الوظيفي لجهاز المناعة
المناعة الفطرية:- النمطية
- عدم الخصوصية
(ينظمه نظام الغدة النخامية الكظرية)
الآليات:
الحواجز التشريحية والفسيولوجية (الجلد،
الأغشية المخاطية)
المكونات الخلطية (الليزوزيم، المكمل، INFα
و β، بروتينات المرحلة الحادة، السيتوكينات)
العوامل الخلوية (الخلايا البالعة، الخلايا القاتلة الطبيعية، الصفائح الدموية،
خلايا الدم الحمراء، الخلايا البدينة، الخلايا البطانية)
التنظيم الوظيفي لجهاز المناعة
المناعة المكتسبة:النوعية
تشكيل المناعية
الذاكرة أثناء الاستجابة المناعية
الآليات:
العوامل الخلطية - الغلوبولين المناعي
(الأجسام المضادة)
العوامل الخلوية – الخلايا اللمفاوية التائية والبائية الناضجة
الجهاز المناعي
- مجموعة من الهيئات المتخصصة،الأنسجة والخلايا الموجودة فيها
أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن
العمل ككل واحد.
الخصائص:
تعميمها في جميع أنحاء الجسم
إعادة التدوير المستمر للخلايا الليمفاوية
النوعية
الأهمية الفسيولوجية للجهاز المناعي
حمايةالمناعية
الفردية طوال الحياة
حساب التعرف المناعي مع
تنطوي على مكونات خلقية و
المناعة المكتسبة. مستضدي
طبيعة
الناشئة داخليا
(الخلايا،
تغير
الفيروسات,
كائنات غريبة,
الخلايا السرطانية و
إلخ.)
أو
خارجيا
اختراق
الخامس
كائن حي
خصائص الجهاز المناعي
الخصوصية - "واحد AG - واحد AT - استنساخ واحدالخلايا الليمفاوية"
درجة عالية من الحساسية - الاعتراف
AG بواسطة الخلايا ذات الكفاءة المناعية (ICC) على المستوى
جزيئات فردية
الفردية المناعية "خصوصية الاستجابة المناعية" - للجميع
الكائن الحي له خصائصه الخاصة، وراثيا
نوع من الاستجابة المناعية الخاضعة للرقابة
مبدأ التنظيم النسيلي - القدرة
جميع الخلايا داخل استنساخ واحد تستجيب
لمستضد واحد فقط
الذاكرة المناعية هي قدرة الجهاز المناعي
تستجيب الأنظمة (خلايا الذاكرة) بسرعة و
بشكل مكثف لإعادة دخول المستضد
خصائص الجهاز المناعي
التسامح هو عدم استجابة محددة لالمستضدات الخاصة بالجسم
القدرة على التجدد هي خاصية لجهاز المناعة
أنظمة للحفاظ على توازن الخلايا الليمفاوية بسبب
تجديد المجمع والسيطرة على سكان خلايا الذاكرة
ظاهرة "الاعتراف المزدوج" بالمستضد بواسطة الخلايا الليمفاوية التائية - القدرة على التعرف على الأجسام الغريبة
المستضدات فقط بالاشتراك مع جزيئات MHC
التأثير التنظيمي على أجهزة الجسم الأخرى
التنظيم الهيكلي والوظيفي لجهاز المناعة
هيكل الجهاز المناعي
الأعضاء:مركزي (الغدة الصعترية، نخاع العظم الأحمر)
الطرفية (الطحال، الغدد الليمفاوية، الكبد،
تراكمات لمفاوية في أعضاء مختلفة)
الخلايا:
الخلايا الليمفاوية، الكريات البيض (mon/mf، nf، ef، bf، dk)،
الخلايا البدينة، البطانة الوعائية، الظهارة
العوامل الخلطية:
الأجسام المضادة، السيتوكينات
مسارات تداول المحكمة الجنائية الدولية:
الدم المحيطي، الليمفاوية
أعضاء الجهاز المناعي
ملامح الأجهزة المركزية للجهاز المناعي
تقع في مناطق من الجسممحمية من التأثيرات الخارجية
(نخاع العظم - في تجاويف نخاع العظم،
الغدة الصعترية في تجويف الصدر)
الموقع هو نخاع العظم والغدة الصعترية
تمايز الخلايا الليمفاوية
في الأجهزة المركزية لجهاز المناعة
الأنسجة اللمفاوية في حالة غريبة
البيئة الدقيقة (في نخاع العظم -
الأنسجة النخاعية، في الغدة الصعترية - الظهارية)
ملامح الأجهزة الطرفية للجهاز المناعي
يقع على طرق الممكنإدخال مواد غريبة إلى الجسم
المستضدات
زيادة تعقيدها باستمرار
المباني حسب الحجم و
مدة المستضد
تأثير.
نخاع العظم
المهام:تكون الدم لجميع أنواع خلايا الدم
مستضد مستقل
التمايز والنضج ب
- الخلايا الليمفاوية
مخطط تكون الدم
أنواع الخلايا الجذعية
1. الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCs) –تقع في نخاع العظام
2. السيقان الوسيطة (اللحمية).
الخلايا (MSCs) – مجموعة من الخلايا متعددة القدرات
خلايا نخاع العظم قادرة على
التمايز إلى عظمي المنشأ، غضروفي،
خطوط الخلايا الدهنية والعضلية وغيرها.
3. الخلايا السلفية الخاصة بالأنسجة
(الخلايا السلفية) –
خلايا سيئة التمايز
الموجودة في الأنسجة والأعضاء المختلفة،
هي المسؤولة عن تحديث سكان الخلية.
الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSC)
مراحل تطور شركة جلاكسو سميث كلاينمتعدد القدرات خلايا جذعية- تتكاثر و
يتم التفريق إلى السيقان الأم
خلايا النخاع واللمفاويات
الخلايا الجذعية السلفية - محدودة في
الصيانة الذاتية، وتنتشر بشكل مكثف و
يفرق في اتجاهين (الليمفاوية
و النخاعي)
الخلية السلفية - تفرق
إلى نوع واحد فقط من الخلايا (الخلايا الليمفاوية،
العدلات، وحيدات، الخ.)
الخلايا الناضجة - الخلايا اللمفاوية التائية والبائية والوحيدات وما إلى ذلك.
مميزات شركة جلاكسو سميث كلاين
(العلامة الرئيسية لـ HSC هي CD 34)سوء التمايز
القدرة على الاكتفاء الذاتي
تتحرك عبر مجرى الدم
إعادة توطين الدم والمناعة بعد
التعرض للإشعاع أو
العلاج الكيميائي
الغدة الزعترية
يتكون من فصيصاتالنخاع.
لكل منها قشرية
و
يتم تمثيل الحمة بواسطة الخلايا الظهارية،
تحتوي على حبيبة إفرازية تفرز
"العوامل الهرمونية الغدة الصعترية."
يحتوي النخاع على الغدة الصعترية الناضجة، والتي
شغله
الخامس
إعادة التدوير
و
يسكن
الأجهزة الطرفية لجهاز المناعة.
المهام:
نضوج الغدة الصعترية إلى خلايا T ناضجة
إفراز هرمونات الغدة الصعترية
تنظيم وظيفة الخلايا التائية في الآخرين
الأعضاء الليمفاوية من خلال
هرمونات الغدة الصعترية
الأنسجة اللمفاوية
- نسيج متخصص يوفرتركيز المستضدات، اتصال الخلايا مع
المستضدات، ونقل المواد الخلطية.
مغلفة – الأعضاء اللمفاوية
(الغدة الصعترية، الطحال، الغدد الليمفاوية، الكبد)
غير مغلف – الأنسجة اللمفاوية
الأغشية المخاطية المرتبطة بالجهاز الهضمي ،
الجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي
النظام الفرعي اللمفاوي للجلد -
منتشر داخل الظهارة
الخلايا الليمفاوية والغدد الليمفاوية الإقليمية والأوعية
التصريف اللمفاوي
الخلايا الليمفاوية هي الوحدة الهيكلية والوظيفية لجهاز المناعة
محددتوليد بشكل مستمر
تنوع الحيوانات المستنسخة (1018 متغيرًا في T-
الخلايا الليمفاوية و 1016 متغيرًا في الخلايا الليمفاوية البائية)
إعادة الدورة الدموية (بين الدم والليمفاوية).
في المتوسط حوالي 21 ساعة)
تجديد الخلايا الليمفاوية (بسرعة 106
الخلايا في الدقيقة)؛ بين الخلايا الليمفاوية المحيطية
الدم 80% خلايا ليمفاوية ذات ذاكرة طويلة العمر، 20%
الخلايا الليمفاوية الساذجة التي تتشكل في نخاع العظم
ولم يكن لديهم اتصال مع المستضد)
الأدب:
1. خيتوف ر.م. علم المناعة: كتاب مدرسي. لطلاب الجامعات الطبية - م: GEOTAR-Media،
2011.- 311 ص.
2. خايتوف ر.م. علم المناعة. نورم و
علم الأمراض: كتاب مدرسي. لطلاب الجامعات الطبية و
الجامعة- م.: الطب، 2010.- 750 ص.
3. علم المناعة: كتاب مدرسي / أ.أ. ياريلين.- م.:
جيوتار-ميديا، 2010.- 752 ص.
4. كوفالتشوك إل.في. علم المناعة السريرية
والحساسية مع الأساسيات العامة
علم المناعة: كتاب مدرسي. – م: جيوتارميديا، 2011.- 640 ص.